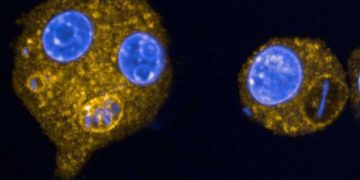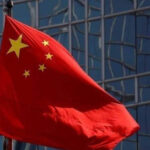لم تكن العداوة والبغضاء التي ابداها التكفيريون وداعميهم من غير العرب تجاه سورية في بداية الحرب عليها، أشد مضاضة من جفاء بعض الأشقاء العرب وتخليهم عنها ولحوقهم بركب الدول الكبرى السائرة على طريق تدمير سورية وتهديد وحدتها وسلامة اراضيها وتشريد شعبها.
هذا الجفاء الذي لاقى على ارض الواقع ترجمات عديدة تراوحت بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي كان له أثاره المعنوية الأشد قسوة من المادية التي زادت من تدهور الأوضاع وتدحرجها باتجاه الأسو في سورية.
واليوم بعد ميلان كفة الميزان لصالح سورية وتكشّف الكثير من خيوط المؤامرات التي كانت تحاك ضدها، واثبات سورية قيادة وشعباً لمصداقيتها ودعم ناجم عن ثقه بالدور والمكانة من الصديق الحليف الدولي قبل الإقليمي، وتحت تأثير عوامل أخرى ارتبطت بمجمل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تعج بها الساحة الدولية، فقد عادت بعض الدول العربية إلى الحضن السوري قناعة بأحقيتها ومصداقيه نهجها تارة ورضوخاً إلى الواقع، حيث السوري ثابت ينجز ويتقدّم رغم أزماته وحرمانه من الكثير من مقومات الحياة والاستقرار والاستمرار.
وبعيداً عن الغرق بالتفاصيل التي جعلت العرب يعودون إلى سورية، لعل ما يسمى بالانفراج الدبلوماسي هو ما يحدث الأن سواء على الصعيدين الاقليمي من جهة أو الدولي من جهة أخرى.
فبعد تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2011م وقيام العديد من الدول العربية بسحب مبعوثيها من دمشق ورغم محاولة الدولة الجزائرية الشقيقة والحليفة الوثيقة اقناع الدول العربية بعودة سورية إلى الجامعة، وإنهاء تعليق عضويتها عقب استضافتها أول قمة بعد جائحه كوفيد 19، إلى أنّها لم تفلح بذلك ليبقى هذا الجهد العربي والأخوي محسوباً لها، إلا أنّ تصريحات وزير الخارجية السعودي الحالي في 19 شباط في منتدى ميونخ حول بدء تشكّل إجماع عربي على أنّه لا جدوى من عزل سورية، وأن الحوار مع دمشق مطلوب ، علماً كان قد سبق له وصرح بأنّ هناك تمهيد لعودة سورية إلى الجامعة الدول العربية.
ولقد انتعشت الآمال من منظور العرب عموماً والسوريين خصوصاً بعد توقيع الاتفاق الأخير بين ايران والسعودية حول تسوية خلافاتهما وتطبيع علاقاتهما، الأمر الذي لقي ترحيباً من الجانب السوري، جاء صراحة على لسان السيد الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته للرئيس الروسي في موسكو نظراً لما يمكن أن يترتب عليه من مفرزات إيجابيه، ستعم نتائجها دول المنطقة بأسرها بما في ذلك إحباط الصورة النمطية، التي حاول الغرب خلقها وزرعها في الذهنية العربية حول أن “ايران عدو وليست صديق”، الأمر الذي تحاول اثباته مراراً وتكراراً منذ عام 2003م، أثناء حضور الرئيس أحمدي نجاد لمؤتمر الدوحة لتبديد الخلافات والمخاوف وصولاً الى زيارة الرئيس حسن روحاني عام 2017م، وسعيه لحل سوء التفاهم مع دول الخليج، وصولاً إلى محاولات الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي لرأب الصدع وحل الخلافات مع المحيط المجاور له.
ولعل اتفاق إيران والسعودية بحال تم فعلاً، فإنّ نتائجه الإيجابية ستطال الصعيد الإقليمي قاطبة بما في ذلك سورية، لما له من دور فعّال في إنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها منذ زمن.
ومن منطلق الثقل الإقليمي للمحور الخليجي على المستوى العربي عموماً والإسلامي خصوصاً فلا يمكن اغفال الثقل الإقليمي للمحور الخليجي ودوره في حسم الحرب الحالية ضد سورية، ومعالجة اثارها السلبية والكارثية، وهنا نقف باحترام أمام الدور الإماراتي انسانياً وسياسياً، فالإمارات أحد أهم دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الوزن السياسي والاقتصادي كما تمثّل الوجه الحضاري العالمي ما تزال تؤدّي دور إيجابياً بخصوص الحالة في سورية.
ولقد شهد العالم على مرأى العين زيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى الأمارات العربية المتحدة التي سبقتها سلسله زيارات لوزير الخارجية الإماراتي إلى سورية في محاولات كثيرة من جانبهم لرأب الصدع، وتحقيق المزيد من التنسيق باتجاه إيجاد مخارج للخلافات العالقة التي تعتري الصف العربي، ولا يمكن تجاهل حالة التضامن العربي التي تواكبت مع الخراب والدمار الذي تسبّب به الزلزال المدمر الأخير في سورية، حيث تبعه إسعاف بعض الدول العربية على رأسها العراق والجزائر والأمارات لسيلٍ هائلٍ من المساعدات الإنسانية مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سورية في مهنتها، فكان لذلك منعكساتها السياسية من حيث تحقيق المزيد من التقارب و الرغبة بإيجاد الحلول والتسويات بقصد عودة سورية كما كانت قبل الحرب عليها.
والجديد بالأمر زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر العربية بعد انقطاع دام 12 عاماً ضمن سلسله الانفراجات الدبلوماسية التي تشهدها الدولة السورية، والتي رأى بعض المراقبين أنّها تمهيداً إلى العودة الميمونة إلى سورية على الساحة العربية، علماً أن مصر أكّدت بأكثر من موقف تمنياتها وحرصها على عودة سورية إلى المحيط العربي.
هذا وتأتي أهميه هذه الزيارة من أهميه مصر ذاتها بالنسبة لسورية، وكذلك أهميه سورية بالنسبة لمصر، فكلاهما عمق استراتيجي للأخر وبينهما قواسم مشتركة، ظهرت بوضوح مع بداية الحرب على سورية أهمها حربهم ضد حركات الإسلام السياسي وحماية مرجعية الدولتين من الأيديولوجيات الجامدة التي تعاني من ديماغوجية فكرية، إضافة إلى احتضان قطاع واسع من الشعب المصري للمشروع القومي العربي الذي يشكّل جوهر النضال السوري ضد الممارسات والمخططات الصهيونية والأمريكية على أصاله عروبة الجيشين العربيين المصري والسوري ومكانتهما عربياً واسلامياً على الساحتين الإقليمية والدولية أيضاً .
وعلى الصعيد الدولي كانت بداية مؤشرات الانفراجات مع الزيارة التي اطلقها الرئيس الصيني عقب محادثات ثنائية أكد في خضمها على بناء عالم متعدّد الأقطاب ومعارضتهما بشدة أي دول أو تكتلات تضر بمصالح الدول الأخرى، ولعل دعمهما لسوريا في ملاحظة في مناهضتها لما يمارس ضدها عالمياً من انتهاكات لسيادتها، يأتي ضمن المضمار المعلن للرئيسين الصيني والروسي على وجود علاقات وثيقة بينهما وبين سورية التي أثبتت مصداقيه مواجهتها للمخططات الصهيونية والأمريكية.
وبالمجمل إن الواقعية والمبدئية السياسية في النهج السياسي السوري تتجلّى واضحة رغم الحاجة الملحّة لأي انفراج دبلوماسي من شأنه إخراج الدولة السورية من الحرب والحصار المفروضين عليها منذ عام منذ 12 سنة، إلا أنّها لم تتخلّى عن مبادئها وخطوطها الحمر، والتي قامت الحرب بسببها، كما لم تقع فريسة التسّرع للقبول بالعروض الوهمية التي تبرز بوصفها موضع شك وريبة، كما هي الحالة بالنسبة للتركي المقدم على انتخابات رئاسية، وقد يكون التقارب من سورية بمثابة ورقة سياسية تخدم أغراض الانتخابات، حيث اعتمدت سورية النظر إلى حقيقة الأمور وجوهرها، وغض الطرف تماماً عن السطحيات والظواهر، وحققت بذلك الركن الجوهري الذي تقوم عليه الواقعية، كما اعتمدت مصالحها ومبادئها معياراً للتقييم والتعامل ، فزاوجت بذلك بين الواقعية والمبدئية في نهجها السياسي، واللذان تجليا بوضوح برفضها التخلّي عن الإرث العملي والنظري الذي حاولت سورية قيادة وجيشاً وشعباً أن تحميه خلال سنوات الحرب عبر ما قدّمته سورية من تضحيات مادية وبشرية، ولأنّ ذلك يعني ببساطة نسف لهذا الإرث المذكور، ولا أدّل على ذلك من المفاوضات الجارية في موسكو مع التركي، والتي اشترط بها السوري قبل كل شيء إنهاء الوجود العسكري والانسحاب من الاراضي السورية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقيه المبادئ والمطالب التي تقدّمت بها من قبل ليثبت لدول العالم أجمع أن حالة سورية ووضعها الحرج اقتصادياً وسياسياً لم يضطرها للاستغناء عن مبادئها التي قدّمت الكثير لأجلها، واتت أكلها حين بنى حلفاء سورية من الدول الكبرى على أساس النجاحات السورية بوصفها حليفاً لهم ليتكلم الجميع اليوم عن تشكيل عالم متعدّد الأقطاب قد لا نبالغ إذا قلنا أن الحرب السورية كانت نقطة الانطلاق فيه.
بقلم د. ساعود جمال ساعود