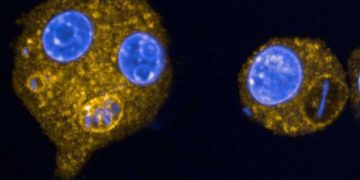كان صوت الطاحون ذي الايقاع الثابت أول ما تسمعه حين تزدلف عالم السكينة حيث يقيم جدي وجدتي , البيت المعمور فوق تلة العرعر القديم والذي بناه بساعديه غرفةً غرفه , والمشغل المليء بأدوات النجارة والحدادة والزراعة , والحظيرة التي تعود إليها الأبقار ذات الأجراس مع الراعي مساءً , والأرض الممتدة حتى النهر الذي تتواجد فيه الأسماك في الغبابيط في آخر الصيف , والناس شديدو الطيبة الذين لا يحتاجون دعوةً إلى العمل والأجر ,والعجائز اللاتي يقبلن الخدود بملء الفم , كان ذلك العالم الذي شَكَّل طفولتي المبكرة في أوائل الثمانينات , كان العالم الذي بناه جدي أبو سليمان بقبضتيه القويتين وعقله الجميل .
كان طفلَ أمهِ الوحيدَ المدلل المولود في عام 1925 على وجه التقريب يوم فشل والده الشيخ صالح في أن لا يتعلق به بعد أن خسر أخويه قبله بثمانية سنوات إذ كان موت الأطفال شائعاً في ذلك الوقت ,وكان الآباء يتعمدون القسوة في المشاعر وعدم ملاعبة أطفالهم حتى لا تنكسر قلوبهم حين يسطو الموت عليهم, وقد قيض لجدي أن يعيش التجربة المرة في أصغر أطفاله ذي السنوات الثلاث مطلع الخمسينيات حين لسعت الطفلَ أفعى بينما كان والده غائباً .. يومها أخذته جدتي على ظهر حصان إلى مصياف التي تبعد حوالي العشرة كيلومترات وعلى طول الطريق كان أهل القرى يسقونه الحليب كدواءٍ لا يعرفون غيره للعلة المميتة ,ولكن الطفل توفي عندما وصل متأخراً إلى الطبيب وحين عاد جدي في المساء وجد جثمان طفله الأحب إلى قلبه مسجىً أمامه .. في تلك اللحظة أدرك أن اختباراته القاسية قد بدأت , عندها تصبر وتجلد وهو يدفنه في قرٍ صغيرٍ على التلة بجانب البيت .
أخوا جدي الذين توفيا قبله كان قد رثاهما الشيخ سليمان الأحمد عضو مجمع اللغة العربية والذي كان زائراً دائماً للبيت
شفعت مصيبتهُ مصيبةَ صالحٍ .. فالقلبُ باتَ سليبَ تلكَ وهاتِه
يتذكر جدي عندما كان طفلاً سؤالَ الناسِ للشيخ سليمان عن حقيقةِ أن المطرَ ليس من عند الله وأنه يتبخر من الأنهار والبحار ويتذكر جوابه الدبلوماسي لهم حين قال لهم بأنه يتبخر بإرادة الله وهو من عنده كان ذلك درسه الأول في الحوار حين كان يصب الماء للشيخ سليمان والذي سمى بِكره باسمه تيمناً به
كان الشيخ سليمان والشيخ معلا ربيع هما أستاذاه اللذان علماه اللغة العربية والفقه وهما من أخرج منه كل تلك اللطائف والأشعار , حيث اعتاد المعلمان أن يجلسا على طرف المعول الخشبي حين يزورهم تلاميذهم أثناء العمل كتعبيرٍ لطيف عن عدم الحاجة للمساعدة وكف الاحراج وكان أبواه نذرا إن استجاب الله لدعاء الشيخ معلا بأن يهبهما إياه أن يجعلانه تلميذه في المعرفة وكان الأمر .
الطفل صاحبُ الذوق والذي يحب النظافة والرتابة والمحاط بعنايةِ وحرصِ والديه حتى بعد أن زوجاه مبكراً والمنصرفُ إلى المعرفة خرج ذات يومٍ في سن الرابعة عشر ليدير الماء من كاف الحبش باتجاه الأرض ولأنه كان يافعاً ومدللاً كان يرتدي قنبازاً شديد البياض وأدرك وهو يعمل أنه يحتاج لباساً للعمل .. وما إن بدأ بالعمل فإنه لم يتوقف قط حتى نهاية عمره
كانت مواكبته في العمل مرهقةً حتى على شاب مثلي في منتصف عقد التسعينيات إذ كان يجهد نفسه ؛ الأمرُ الذي سبق ولاحظه والده عندما كان يراه وهو يعمل , ذات مرة جلب له (طبقة ) تتن وهو الاسم السرياني للدخان وقال له بأنه يليق به أن يدخن ولكن جدي كان ينساها دائماً عندما يذهب إلى العمل وكان والده يلحقه بها ويعاتبه على نسيانها عندها قال له بأنه لم يحب التدخين فأجابه بأنه يشفق عليه حين يراه يعمل وأنه قال لنفسه لعله إن تعلم التدخين يريح نفسه من العناء للفه وتدخينه .
لم يكن أبو سليمان مقتنعاً من التكسب سوى بعرق الجباه رغم أنه كان محافظاً في منظور القيم لذلك حين خُير بين المعول والمسبحة اختار المعول للرزق وبدأ يعمل في العمارة حين اقتنى قالباً خشبياً لصب البيتون عندما دخل البناء البيتونيُ الجبال ,كذلك اقتنى ورشة حدادة لإصلاح أدواته الزراعية بدايةً ثم لصنع بعض النوافذ والأبواب وكانت له اهتماماته في الخشب لذلك زرع مساحةً كبيرة بشجر الحور واقتنى منشرةً خشبية وبدأ بصناعة الموبيليا ولست أدري كيف تعلم كل هذا ,ثم أجاد فيه حين ابتدع قالباً لصب كنار الباب ووضع السقاطة فيه مستغنياً بالمطلق عن الكنار الخشبي ثم رأيته في مطلع الثمانينات يفرط حبات الزيتون بمشطٍ حديدي صنعه بنفسه الأمر الذي سيشيع بعد الألفين بمشط بلاستيكي شبيه .
ذات مرةٍ في شبابه زاره أحد الرحالة اليونانيين ومكث عنده لفترة وأحب الرجل أن يكون ممتناً للضيافة فعلمه تركيب دواءٍ خاص لمرض الأكزيما الذي كان بلا علاجٍ في ذلك الوقت وما أزال أتذكر الرائحة النفاذة للدواء الذي كان جدي يقدمه
بشكل شبه مجاني لكل مريض يزوره . حاول جدي الذي ولد في فترة الاحتلال الفرنسي أن يقيم عالمه المستقل بعيداً عن اضطرابات السياسة يومَ كانت الدولة لا تعني لأولئك السكان إلا الشر المستطير , كان طفلاً يوم اكتشف أحد المستشرقين الفرنسيين أن شعباً كاملاً يعيش في تلك الجبال لا يعرف عنه العالم شيئاً وكان يسمع القصص عن إذلال الرجال في المدن وسومهم سوء العذاب وامتطاء ظهورهم في بعض الأحايين وقصص المذلة أثناء التوجه للحصاد في السهول الداخلية التي ينتشر بها الاقطاع وأدوات الدولة العثمانية لذلك أصرَّ ومن خلال تعدد مواهبه أن يبني عالماً مستقلاً لا يحتاج به شيئاً من المدينة فكان يزرع قمحه وخضاره وثماره ويصنع حاجياته وأدواته ولكنه لم ينجح في كل مرةٍ في تجنب المشاكل, ذات مرة أدت به شهادة حق مع الخوري تريفو إلى صِدام مع أحد متنفذي السلطة الأثرياء والذي أرسل زعرانه لسرقة مصاغٍ ذهبي وثور كان يمتلكه وحين ذهب إليهم أحد أقرباءه ليستعيد منهم الذهب والثور أطعموه من لحمه .. كظم غيظه وترك ثأره للأيام التي أرته بأم عينه ذلك الرجل السيء كهلاً في مصياف يتسول طعاماً فلا يُطعم .
كان أبو علي شاهين يلوذ بداره أحياناً أيام ثورته وكان يحترم الرجلَ الذي حارب من أجل كرامته دولةً باغيةً في ذلك الوقت وإقطاعاً منحطاً لذلك احترمَ جدي دولة البعث حين قامت وكان يقارنها بما تحتفظ به ذاكرته من قصص الإذلال التي عاشها أجداده وبما يعرفه عن نواميس الدول تاريخياً وأذكر ذات مرةٍ أنه حل إشكالاً بيني وبين أحد زواره _الذي عبر عن عدم مبالاته بما يعرضه التلفزيون من معاناة الفلسطينيين _ على طريقة معلمه الشيخ سليمان في مراعاة جهل زائره وغيرتي القومية الغاضبة .
كان رجلاً عاقلاً يضع الشيء مواضعه ويحل أي مشكلةٍ مهما بدت معقدةً ويجبر الخواطر ويعين الضعفاء ويعلّم السائلين وكان يعتقد بأن الفقر آفة المسلمين في تلك الجبال لذلك قدَّس العمل وبنى من ماله وعلى أرضه مسجداً سماه مسجد سعد وبجانبه ابتنى مقاماً لجده وأبيه بعد أن احتفر لنفسه قبراً فيه بيديه وجهزه ؛ ثم كتب على المقامِ أبياتاً منها :
وناجاهما يرجو قبولَ كثيفهِ .. بقربهما إن حاديَ الموتِ أزمعا
سألته يومها بعد أن سحرتني الصورة كيف خطرت له فأجابني بأنه تخيل الأجل بيد حادٍ يقود الآجال ويستريح بها على تلة العرعر وأنه حين يحين أجله سيزمع هذا الحادي الترحال , سكنت هذه الصورة ذهني لدرجة أنني كنت أرى بعين خيالي ذلك الحادي مستريحاً بجانب الشجرة الكبيرة على التلة في المساءات المنعشة .
كان رجلاً قوياً لا يشكو وإن كان في قرارته يعيش وحشةَ الوجود لا سيما بعد أن افتقد جدتي منذ خمسة عشر عاماً وافتقد بعدها ولده خلال أقل من عام , أتذكر في تلك الليلة زيارة الشيخ حيدر العبود المعزية له قبل الجنازة وذلك الحديث جَمَّ الأخلاقِ والحكمة الذي دار بينهما وابتسامة الحزن اللطيفة التي تبادلاها , كان يعبر لي عن تلك الوحشة من خلال قراءة مطولة في ديوان الشيخ سليمان الأحمد ذات ظهيرةٍ على التلة تحت شمسٍ لطيفة وكان من خلال صوته وقراءته الفصيحة يتبنى كل حرفٍ من ألام ذلك العالم الجليل .
ولكنه كان رجلاً حاضر الدعابة وتضحكه اللطائف الدقيقة التي كنتُ أدّخرها لجلساتنا من بطون الكتب وزوايا التراث وتهزه الأشعار الجميلة وذات مرة دخل عندما كانت تقول لنا جدتي بأنه لم يسبها طوال حياته وحين سألناه أنه كذلك ؟ أجاب بالتأكيد بأنه لم يفعل ثم أكمل : لأنني إن قلت لها أبوكِ ستقول لي أبوك وأبو أبوك .
عندما اندلعت الحرب مطلع 2011 أمَّ الناسَ في صلاة الجنازة على الشهداء ما وسعه ذلك , وكان مستبشراً بالنصر رغم يقينه بفداحة الخسائر وكانت النتيجةَ السابحةَ على تيار الشواهد يراها جليةً في عين عقله ,وقبل حوالي الشهرين روى لنا مناماً عن مسيره على طريقٍ خريفي حين مرت بجانبه سيارة عالية كان فيها أحد إخوانه الأتقياء الراحلين والذي هتف له جدي ( إلى أين تمضون وتتركونني ؟؟) فأجابه الرجل مع ابتسامة ( لقد جئنا خصيصاً لنأخذك ) . فكان أن صعد السيارة ومضى معهم لذلك قال لنا حين كنا نعد له المدفأة بأنه لن يقضي معنا هذا الشتاء .
في طريق الجنازة من مصياف كان أبناء وأحفاد الذين سقوا طفلهَ الحليب يشعلون البخور وينثرون الرز والورود وكانت الجنازة طافحةً بالوجوه المحزونة وغدا قبره مزاراً للكثير من الشباب الذين يعرفونه والذين يسمعون به , وأنا حين وقفت على تلك التلة قبل أن يدركني الرحيل أحسست بغيابِ ذلك الحادي الذي مكث ينتظره لمئة عام ,وتبدى لي أني سمعت صوتَ حداءٍ حزينٍ وخافت , عادتني في تلك اللحظة ابتسامته الجميلة التي أضاءت محياه حين قرأت له شعراً لي استئناسا بقصيدة جدنا السيد المكزون : متى يَنشَقُّ عَن جَسَدي الضَريحُ. وَيُنفَخُ فِيَّ مِن ذي الرَوحِ روحُ.
قلتُ له حينها معبراً عن وحشتي كما وحشته : متى تشرق بنورِ اللهِ أرضي .. فأغدو والعيانُ بها صحيحُ
وينكشفُ الطريقُ إلى حبيبٍ …. جَفَاهُ الذنبُ والكَلِمُ القبيحُ
حملت وحشتي وانصرفت .
لذكرى الشيح أحمد صالح سعد.